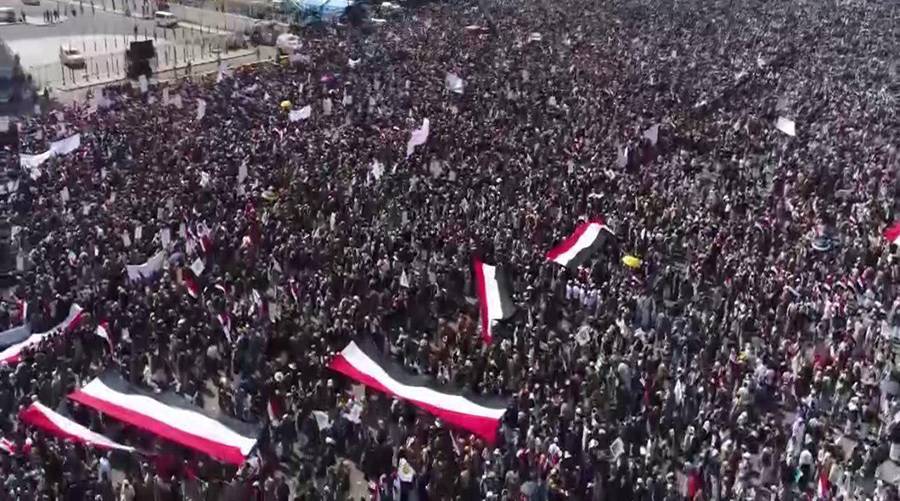وكما هو حال نظام صالح، فإن التحالف مع القوى الرجعية والمتخلفة وحرف الصراع عن مساره، بوصفه صراعا بين الغالبية المفقرة من الشعب والقوى المساندة له الطامحة إلى خلق دولة العدالة والمواطنة المتساوية وبين القوى المهيمنة على السلطة والثروة، إلى جعله صراعا بين جهات وطوائف ومشاريع ما قبل وطنية.
لقد بدا هذا واضحا في تحالف الحوثي وصالح الطائفي الذي اعتمد بدرجة أساسية على استثمار مخاوف المناطق القبلية الشمالية من خلال تصوير موجة التغيير بأنها تستهدف مصالح هذه القطاعات القبلية وتريد حرمانها من مصادر العيش. خصوصا أثناء ما كان الحديث يدور عن صيغة الدولة الاتحادية. وقد لاقى هذا الترويج استجابة واسعة فقط لمجرد وجود قطاعات واسعة في هذه المناطق تعتمد في معيشتها على تغلغلها في جهاز الدولة العسكري أساسا، ثم الإداري وما يتخلق عنه من مصالح غير مشروعة يجنيها غالبا مشائخ القبائل وكبار ضباط الجيش وليس أبناء القبائل. إلى جانب ترويج أوهام أخرى بالطبع، كأوهام حق المناطق الشمالية في الحكم، وأوهام منع خروج الحكم من المنطقة الزيدية، وليس آخرها استثمار جهل ومستوى وعي أبناء القبائل لتسويق حكاية السلالة المقدسة مرة أخرى.
غير أن هذا ليس هو كل الحكاية، إلى جانب بؤس القوى السياسية التي تصدرت المسار الثوري، بينما هي قوى إصلاحية، وأيضا أزمة القوى الثورية، وهي مسائل يمكن نقاشها بشكل مفصل في مقال مستقل.
في هذا المقال سوف نناقش مصالح القوى الإقليمية ودورها في وصول الوضع في اليمن إلى هذا المستوى الجحيمي.
هدف التدخلات الخارجية
عادة الحرب التي تقودها ثورة مضادة يكون هدفها الرئيسي هو معاقبة الثورة والجماهير الواسعة التي بادرت إلى إشعالها، لكن هذه الحرب بحكم طبيعتها القذرة، تفتح الباب أمام كل الأوهام وأمراض التاريخ لتطفو على السطح، وتوفر أيضا مناخا ملائما لتدخلات القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك المخاوف من الثورات ومن مخاطر امتداد رياحها إليها. غير أن الشكل النهائي لأي تدخل خارجي في البلدان التي تشهد حروبا أهلية، دون أن يتخلى عن طبيعة معاداة الثورات، يكون في الأساس بهدف الاستقواء به على الشعب، وأحيانا استثمار إمكانية تفتيت القوى الشعبية ولو من خلال ادعاء مناصرتها، ثم انسجاما مع رغبة هذه الدول المتدخلة التي تريد استثمار ظروف الحرب للظفر بمساحة نفوذ جديدة ومصالح يمكن الحصول عليها. للاعتبار الأخير تحديدا يكون هناك تدخلات مزدوجة مع هذا الطرف أو ذاك، ولعل هذه الصورة باتت تختصر كامل المشهد في اليمن عند الحديث عن التدخل الخارجي.
انتقام صالح في خدمة إيران
إن الصراع الذي فجرته جماعة الحوثي بدعم من إيران، كان قد تضافر مع تواطؤ وترتيبات وفرها صالح، عندما كانت الرغبة في الانتقام من ثورة فبراير التي هزت سلطته في أوجها، فهذه الثورة سمحت للتناقضات أن تبرز، الأمر الذي ترتب عليه تنحيه عن السلطة وإن شكليا، وأيضا فتح الباب أمام كل أنواع التهديدات التي باتت تستهدف مصالحه غير المشروعة وما تبقى له من طموح سياسي.
بالنسبة للتدخل الإيراني وعملية دعم جماعة الحوثي بالمال والسلاح، فقد قام كما تابعنا على قاعدة إعادة فرز المجتمع طائفيا كما درجت عادة السياسات الخارجية لدولة الملالي، وهو أمر يحظى بتواطؤ بعض الدوائر الغربية وتحث عليه شركات السلاح والمستثمرين في الخراب.
هذه الحرب بحكم طبيعتها القذرة، تفتح الباب أمام كل الأوهام وأمراض التاريخ لتطفو على السطح، وتوفر أيضا مناخا ملائما لتدخلات القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك المخاوف من الثورات ومن مخاطر امتداد رياحها إليها
وما يتعلق بالسعودية، فتدخل إيران هذا لم يهدف فقط إلى تصدير الخوف إلى السعودية وتهديد أمنها القومي كما أنه ليس خلافا سنيا شيعيا، بل صراع مصالح مدفوع بأوهام استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية.
حتى عندما يتم إقحام مكة في الصراع، فالأمر لا يختلف كثيرا عن استثمار إيران للقضية الفلسطينية.
ولكن إلى جانب أهداف أخرى عديدة وعندما يتعلق الأمر باليمن، فإن السيطرة على مضيق باب المندب يمثل رغبة استراتيجية لكل القوى الدولية وكذلك الدول الإقليمية التي تمتلك طموحا في الهيمنة، ولعل إيران واحدة من أبرز الدول الساعية إلى امتلاك نفوذ في الممر الدولي الذي يشهد يوميا "مرور 304 ملايين برميل نفط، والمئات من السفن التجارية العملاقة".
الوصاية السعودية ومطامح الإمارات
بالطبع التدخل السعودي المبرر بكونه جاء استجابة لهذه المخاوف، هو الآخر يأتي ضمن استراتيجية الوصاية المتبعة من قبلها والتي ترسخت على مدى ما يقارب نصف قرن، وقد كان من نتائجه ضمان بقاء اليمن بلدا فقيرا ويعاني من مشاكل تتعلق بالاندماج الوطني والاجتماعي ومنفتح على كل أنواع الصراعات. وهذه هي الصيغة التي جعلت الجارة الغنية بالنفط قادرة على استقطاع أراضٍ واسعة في الماضي إبان دولة الإمام يحيى، ثم بعد عقود طويلة تعميد ضم هذه الأراضي باتفاقية رسمية إبان حكم صالح.
لابد أن بقاء اليمن غير قادر على مغادرة وضعه الراهن هو الصيغة الملائمة لضمان استمرار الوصاية. ويبدو أنها استراتيجية سعودية فعلا. فقد برز هذا الحرص واضحا من خلال رعاية السعودية للمبادرة الخليجية التي مثلت التفافا على ثورة فبراير وتطلعات اليمنيين بدولة تضمن لهم العيش بكرامة.
وإذا كان تدخل السعودية في مواجهة الحوثي وصالح مبررا بالنظر إلى التهديد الإيراني فإن تعاملها مع الملف اليمني بنفس طريقتها المعروفة التي تنتقص من تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم المشروعة، يدل على أن الجارة الغنية تواصل سياساتها العقابية بحق هذا الشعب على خلفية قيامهم بثورة كما كان الحال عقب قيام ثورة سبتمبر. لم يتغير سوى الادعاء هذه المرة أنها تقف في صف الشعب.
بالنسبة لدولة الإمارات فلديها عداؤها المعلن مع جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بمثابة القوى الوحيدة المنظمة من بين مختلف القوى المشاركة في موجة الربيع العربي، كثورات أرعبت كل الدول الإقليمية ذات أنظمة الحكم الملكي، خصوصا تلك التي هي بمثابة مكتب عمل مفتوح للدول الكبرى والشركات التجارية العملاقة. لكن هذا العداء تحول من كونه بدافع الهلع في البداية، إلى رغبة في الاستثمار وذلك من خلال تملق مزاج الدوائر الغربية وشعارات الإرهاب، وإن لم تتخلّ الإمارات عن هذا الاعتبار في محاربة جماعة الإخوان المسلمين بالاعتماد على القوى السلفية بدرجة رئيسية، إلا أنه بات من الواضح أن إمكانية السيطرة على السواحل اليمنية التي تمتد على مسافة 2000 كم، قد أثار شهيتها وفتح آفاقا أمام خيالها التجاري الطموح. لكن هناك نقطة ثالثة تتعلق بالأجندة الأمارتية، إلى جانب رغبتها في تصفية الحساب مع جماعة الإخوان المسلمين والسيطرة على سواحل اليمن، فإن علاقتها الجيدة والمتواصلة من تحت الطاولة مع المخلوع صالح قبل مقتله ومع نجله المقيم على أرضها، ثم مؤخرا مع طارق صالح، كل هذا يجعلها معنية بإغراق البلد في الصراعات الجانبية ومحو آثار ثورة فبراير وكل ما يمت لها بصلة. لأن أحد أهداف هذه الثورة التي أسقطت حليف الإمارات من السلطة، يتمثل في استعادة الأموال المنهوبة وكثير من هذه الأموال أصبحت على هيئة استثمارات ضخمة قائمة في دولة الإمارات.
ويبدو العداء الإماراتي للثورة واضحا من خلال دعم كل الجماعات الرجعية والنزعات البدائية التي تحمل مشاريع ما قبل وطنية، عملها الوحيد هو تفخيخ مستقبل اليمنيين. على أن الدور الإماراتي أصبح قائما على استراتيجية ضعف وهشاشة الحكومة الشرعية، والعمل الحثيث على التأليب ضدها لإضعافها أكثر. وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعها تحالف الحوثي وصالح ومن خلفهم إيران. أما السعودية فهي لا تزال تحتفظ بالشرعية إلى حين نضوج خراب البلد وتوفر ظروف ملائمة للانقضاض الشامل. أو هذا ما بدأ يظهر من خلال اهتمام السعودية بمحافظة المهرة ورغبتها في تمرير أنابيب النفط إلى البحر العربي. لقد بات من الواضح أن السعودية لا تعمل على تقوية الشرعية ولا ترغب بذلك، أما اليمنيون فهي تتعامل معهم كمرتزقة.
مأزق الثورة
ما يعكسه تدخل القوى الخارجية في اليمن، بات يشير إلى منهجية تكالب هدفها الأساسي تجاوز فكرة أن ثورة عظيمة كانت قد اندلعت قبل سنوات قليلة، بهدف محو آثارها وتصفية الحساب معها ومعاقبة كل ما يمت لها بصلة ثم إرساء واقع مناقض تماما. أما الدوافع فهي أنه لا يمكن التأسيس لوضع جديد والحفاظ على المصالح غير المشروعة بينما لا تزال الثورة تنبض. ولعل المأزق الحالي للقوى الثورية، يبرز بكون خطابها لم يعد ثوريا تماما، بل بات يعكس حالة من التيه والشتات، كنتيجة حتمية لإلقاء هذه القوى بجميع بيضها مرة في سلة التحالف ومرة في سلة الشرعية، والمراهنة على أن هذا هو الخيار الأفضل.
التدخل السعودي جاء استجابة ضمن استراتيجية الوصاية المتبعة من قبلها والتي ترسخت على مدى ما يقارب نصف قرن، وقد كان من نتائجه ضمان بقاء اليمن بلدا فقيرا ويعاني من مشاكل تتعلق بالاندماج الوطني والاجتماعي ومنفتح على كل أنواع الصراعات.
بالطبع هناك من أصبح يغرد خارج السرب، وهناك قطاعات لم تعد تعرف ما العمل. أما القوى السياسية التقليدية فتعيش أزمتها المستفحلة والتي تظهر على هيئة انزواء ومواقف مرتبكة لكن أيضا على شكل أزمة ثقة فيما بينها وعدم تقدير لحجم التكالب الذي بات يهدد وحدة البلد ومكتسباته الوطنية وحتى مقدراته الاقتصادية. عوضا عن القرار الوطني المستقل. أصبحنا أمام إشكالية بنيوية ومركبة على مستوى الواقع الذي يجري إعادة هندسته بعيدا عن تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم بدولة تضمن لهم العيش بكرامة، وإشكالية على مستوى الفعل وإمكانية الفعل، حيث هذا الأخير يتوفر في الأساس كانعكاس لوضوح الرؤية وأيضا طبيعة الخطاب المتصدر. كل القوى الفاعلة اليوم تتكامل لأجل شيء واحد، وهو تصفية الحساب مع الثورة ومحو أثرها، الأمر الذي سيترتب عليه، في أحسن الأحوال، إعادة البلد إلى أحضان المشاريع الاستبدادية، وفي أسوأها، يبدو أن الأفق اليمني منفتحا على مصراعيه.
إذن لا أحد معني بمواجهة هذا الوضع سوى الثورة وقواها الحية التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بسرعة ترتيب صفوفها وبلورة خطابها المعبر عن مصالح الغالبية العظمى من الشعب للبدء في مجابهة أعداء الثورة وكل التدخلات السافرة التي تتكالب ضدها.
الاعتماد على الشعب وعلى وعيه بحقيقة ما يدور وأين تكمن مصالحه، ثم تنظيمه لأجل انتزاعها يمثل فرصة أخيرة لا تزال متاحة أمام طليعة ثورة فبراير. وهذا يشترط بناء رؤية حول أهمية وضرورة الانفكاك من الاستقطابات القائمة، فمن يقف ضد التحالف ليس بالضرورة مع إيران، ومن ينتقد الشرعية ويجابه فسادها ليس شرطا أنه رحب بالحوثي. لكن هذه مسألة ليست بتلك البساطة ولا يكفي أن نتحدث عنها، بل تتطلب عملا في الواقع وانحيازا نهائيا للناس وتطلعاتهم المشروعة.